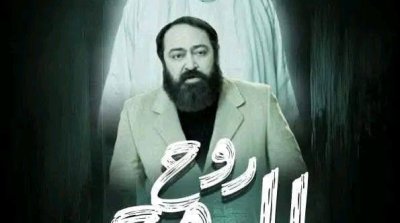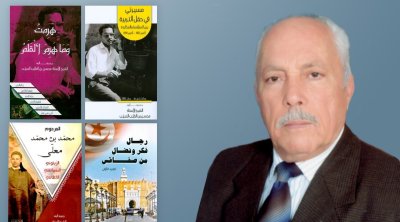أوائل التسعينات، عندما كانت البلاد تتّجه شيئا فشيئا نحو الانغلاق السّياسي بعد "ربيع تونسي" قصير، كان الشاعر محمد بن صالح من أبرز الوجوه في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تجربته في هذا المجال تشهد عليها إلى الآن مقالاته في جريدة "الرّأي" التي كان أحد أهم كتّابها قبل أن تتوقّف عن الصدور مع بداية «العهد الجديد». ورغم أنه كان رقما صعبا في توازنات تلك اللحظة السياسية الحرجة، لم تمانع الإدارة العامة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية عندما استشيرت حول مسألة انضمامه إلى الإذاعة، لم تمانع إطلاقا، بل تحمّست لذلك كثيرا.
صار محمد بن صالح منتجا إذاعيا ثم كتب للإذاعة أفضل أعمالها الدرامية، وقادها إلى منصّات التتويج، دون أن يطالبه أحد يوما بالتنازل عن استقلاليته واهتماماته الحقوقية والنقابية. رغم كل الافتراءات التي تتداول اليوم عن "إعلام العار"، كانت الإذاعة والتلفزة في تلك الفترة بمختلف فروعها مختبرا حقيقيا للتعدّد والتنوّع، وفي استوديوهاتها تقاطعت مسارات الدساترة والتجمعيين والحقوقيين والإسلاميين (المعتدلين) والنقابيين واليساريين والمستقلين والعيّاشة، ونشطاء المجتمع المدني، و"أفندية الجامعة" لتنصهر كلها في نهر الثقافة والإبداع.
كان الإعلام العمومي حريصا على ألاّ يؤدي الانغلاق السياسي بالضرورة إلى غلق المجال الإبداعي. لا سيما مع بعث إذاعات جديدة في الجهات وتأسيس قناة 21 وإذاعة الشباب في العاصمة.
لم تكن التلفزة تفتّش كثيرا في الضمائر، وظلت منفتحة على الساحتين الثقافية والجامعية، فلم يكن ثمة داع لمعاقبة المبدعين والمثقفين وإقصائهم لمجرد الاختلاف السياسي والاستقلالية، ومحمد بن صالح الذي نكرم روحه إذ نتمثل به هنا لم يكن استثناء، فقد استقطب التلفزيون الكثير من الكُتّاب المرموقين ورجال الثقافة والفكر والمبدعين و منهم من اقتحم مجال الكتابة الدرامية، وبفضلهم وجدت الأعمال الرائعة التي ما نزال إلى اليوم نتمتع بمشاهدتها.
ولقد أتاحت وفرة الإنتاج للكفاءات في سائر التخصصات مجالا للعمل والإبداع. والسمعة الجيدة التي يتمتع بها اليوم التقنيون التونسيون أينما حلوا يعود الفضل فيها إلى التلفزة الوطنية، لأن النجاحات الكبرى التي حققتها سابقا كانت أشبه بالسمفونيات، يجتمع فيها الكاتب الجيد بالمخرج المبدع والموسيقار الموهوب ومصمّم الديكور العبقري والأفضل دائما من بين من نسميهم جنود الخفاء.
والتلفزيون العمومي هو السلطة التي تضمن بقاء الكثير من التخصصات التقنية وعدم ذوبانها في زمن صار يستسهل فيه التصوير والإخراج والتمثيل بفضل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وهو الذي موكول له أن يحافظ على المسافة الفاصلة بين الهواية والاحتراف لا سيما بوجود معاهد جامعية تدرس فنون الصورة أكاديميا.
نستحضر اليوم فترة التسعينات لا لنقارن بينها وبين حاضرنا، فما نشهده اليوم من قمع سياسي وزجر للنخب وإقصاء ممنهج للكفاءات أمر مختلف سياقه عما حدث سابقا ولا يمكن مقارنته به، إنما نستحضرها لنشير إلى انحراف التلفزة التونسية التي يمولها دافعو الضرائب عن المصلحة عامة، فمن واجبها أن ترفض أي (وان مان شو) يحتكر فيه شخص واحد وظائف إبداعية مختلفة، لا سيّما أن كل تجاربها المشابهة سابقا آلت إلى فشل ذريع وأفلت مرتكبوها من العقاب تاركين وراءهم جبلا شاهقا من الفضائح المدوية، إننا نستحضر التسعينات لنذكر التلفزيون بماضيه عله يخجل قليلا من المصير الذي ارتآه لنفسه والزاوية التي حشر نفسه فيها، والمآخذ هنا تتّصل بالحوكمة أساسا في انتظار حدوث معجزة ما تسفّهنا وتجعل «بيضة الديك» هذه تنسينا ما نتحسّر عليه.